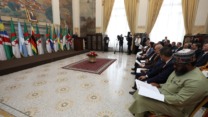-
تحرّك غير رسمي في توقيت حساس.. ماذا أرادت باريس قوله دون أن تصرّح؟
-
استقبال محسوب ورسائل واضحة.. كيف أعادت الجزائر ضبط معادلة الحوار؟
-
من الحاضر إلى 2027.. الجزائر ترسم شروط العلاقة مع ساكن الإليزيه
تأتي زيارة الوزيرة الفرنسية السابقة، ورئيسة جمعية الصداقة الفرنسية-الجزائرية، سيغولان روايال إلى الجزائر، في لحظة دقيقة من مسار العلاقات الثنائية، التي تشهد منذ أشهر توترا سياسيا وإعلاميا متصاعدا.
ورغم أن الزيارة لا تندرج ضمن تحرك دبلوماسي رسمي مباشر، إلا أن مضمون رسائلها، وطريقة استقبالها، وتوقيت بث تصريحاتها، حوّلها إلى حدث سياسي لافت يتجاوز إطار المجاملة، ويفتح باب التساؤل حول ما إذا كانت باريس تبحث عن تهدئة ظرفية، أم أن الجزائر تستثمر هذا التحرك لترسيم معالم علاقة جديدة قائمة على الندية والاحترام، موجّهة ليس فقط لساكن الإليزيه الحالي، بل أيضا لمن سيخلفه في أفق 2027.
في هذا الإطار، حلّت الوزيرة الفرنسية السابقة، سيغولان روايال، بالجزائر في زيارة رسمية، جرى خلالها استقبالها من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ونُشرت عقب اللقاء تصريحات مصوّرة لروايال عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، عبّرت فيها عن تقديرها للاستقبال الذي حظيت به، واعتبرته دليلا على استعداد الجزائر للحوار متى توفّر الاحترام المتبادل والتقدير المتبادل بين الطرفين. وتندرج الزيارة في إطار نشاط سيغولان روايال بصفتها رئيسة جمعية الصداقة الفرنسية-الجزائرية، وهي جمعية تنشط في مجال تعزيز الحوار والتبادل بين الشعبين. وأوضحت المسؤولة الفرنسية السابقة أن زيارتها تندرج ضمن مسعى للاستماع والانخراط في مجالي الابتكار الاقتصادي والتعاون الثقافي، مؤكدة اهتمام الجمعية بتشجيع المبادرات المشتركة ودعم التواصل بين الفاعلين في البلدين. وخلال تصريحاتها، تطرقت روايال إلى عدد من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، من بينها قضايا الذاكرة التاريخية والتعاون الثقافي. وأكدت أن الذاكرة لا تُختزل في منطق الاتهام أو الامتياز، بل ترتبط بجروح تاريخية تستوجب الاعتراف والمعالجة، مشيرة إلى أهمية التعامل مع هذا الملف في إطار الاحترام المتبادل، وبما يخدم بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين الجزائر وفرنسا. كما تناولت المسؤولة الفرنسية السابقة عددا من القضايا ذات الصلة بالموروث الثقافي والتاريخي، من بينها مسألة الأرشيف والممتلكات الثقافية، إضافة إلى ملف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية. وأعربت عن نيتها نقل هذه الانشغالات إلى السلطات الفرنسية، مؤكدة أن زيارتها تندرج ضمن مسعى لفتح آفاق جديدة للتعاون، في سياق يشهد اهتماما متزايدا بمستقبل العلاقات بين البلدين.
ماذا تعني زيارة سيغولان روايال في هذا التوقيت بالذات؟
ويطرح توقيت زيارة، سيغولان روايال، نفسه كعنصر دالّ لا يمكن فصله عن السياق العام الذي تمرّ به العلاقات الجزائرية-الفرنسية، خاصة بعد فترة من التوتر السياسي والإعلامي المتصاعد. فاختيار هذا الظرف بالذات يوحي بأن الزيارة تأتي في لحظة تبحث فيها باريس عن تهدئة الأجواء وكسر حالة الجمود، دون المرور عبر القنوات الرسمية الثقيلة التي قد تُقيّد الخطاب أو تُحرج صانع القرار داخليا. ويزداد هذا المعطى وضوحا عند التوقف عند طبيعة الشخصية الزائرة، إذ لا يتعلق الأمر بمسؤولة حكومية حالية، ولا بمبعوث رسمي يحمل موقفًا مُلزمًا للدولة الفرنسية، بل بشخصية سياسية وازنة من خارج الجهاز التنفيذي. هذا الاختيار يسمح بتمرير رسائل مرنة، واختبار ردود الفعل، وفتح قنوات تواصل غير مباشرة، في وقت تدرك فيه باريس حساسية المرحلة وصعوبة إطلاق مبادرات رسمية واضحة في ظل نقاش داخلي فرنسي محتدم حول ملفات الذاكرة والسيادة والهجرة. وعليه، يبدو أن التوقيت يجمع بين عنصرين متلازمين: حاجة فرنسية إلى خفض منسوب الأزمة دون إعلان مراجعات رسمية صريحة، واستعداد جزائري مضبوط للتفاعل مع أي خطاب يحترم السيادة ويبتعد عن منطق الإملاءات. فزيارة روايال، في هذا السياق، تعكس لحظة اختبار متبادل، حيث لا تُقرأ فقط بما قيل خلالها، بل بالظرف الذي جاءت فيه، وبالرسائل التي اختارت كل جهة تمريرها عبر هذا المسار غير التقليدي.
هل تحمل الزيارة فعليا رغبة فرنسية في تهدئة العلاقات؟

ويُفهم من طبيعة الخطاب الذي رافق زيارة، سيغولان روايال، أن باريس تسعى فعليا إلى إرسال إشارات تهدئة، لكن دون الانتقال إلى مستوى المبادرات الرسمية الواضحة أو الالتزامات السياسية الثقيلة. فالكلمات التي حملت دعوة إلى الحوار واحترام السيادة، والحديث عن ضرورة تجاوز الخطابات الاستفزازية، تعكس إدراكا فرنسيا لحجم التوتر القائم، ومحاولة لامتصاصه عبر رسائل ناعمة تُقدَّم في قالب تصالحي محسوب. غير أن هذا التوجه يظل محكوما بحدود واضحة، أبرزها الغياب الكامل لأي مسار رسمي موازٍ، سواء من قصر الإليزيه أو وزارة الخارجية الفرنسية. فلو كانت باريس بصدد إطلاق مبادرة تهدئة شاملة، لظهرت مؤشرات مؤسساتية مرافقة، أو على الأقل تصريحات رسمية تترجم هذا التوجه إلى موقف دولة. والاكتفاء بقناة غير رسمية يؤشر إلى رغبة في خفض التوتر بأقل كلفة سياسية ممكنة، خصوصا في ظل حساسية ملفات الذاكرة والسيادة داخل النقاش الفرنسي الداخلي. وعليه، يمكن قراءة هذه الزيارة كاختبار نوايا أكثر منها إعلانا عن تحول استراتيجي في العلاقات الثنائية. ففرنسا تبدو راغبة في تهدئة المناخ العام وفتح نافذة تواصل، دون الدخول في مراجعات جوهرية أو التزامات قد تُقيّد حركتها لاحقًا. إنها محاولة ضبط إيقاع الأزمة لا حلّها، وشراء وقت سياسي إضافي، في انتظار ظروف داخلية وخارجية قد تسمح بطرح مقاربات أوسع، وهو ما يجعل “الهدنة” المطروحة أقرب إلى مناورة تكتيكية منها إلى مسار تسوية متكامل.
كيف تعاملت الجزائر مع الزيارة؟ ولماذا بهذا الشكل؟

تعاملت الجزائر مع زيارة، سيغولان روايال، ببرودة محسوبة وهدوء واثق، عكس أي انطباع عن استعجال أو بحث عن مخرج ظرفي للأزمة. فقد تم الاستقبال في إطار رسمي واضح، عبر أعلى هرم الدولة، ما منح الزيارة وزنا سياسيا مدروسا دون أن يرقى بها إلى مستوى زيارة تفاوضية. هذا الاختيار يعكس إدراكا جزائريا لطبيعة الشخصية الزائرة وحدود تمثيلها، ويؤكد في الوقت ذاته أن الجزائر لا تُغلق أبوابها أمام الحوار، لكنها تتحكم بدقة في شروطه وإيقاعه. كما امتنعت الجزائر عن الانخراط في أي ردّ فوري أو تفاوض علني، ولم تُقابل الخطاب التصالحي بخطاب مماثل، ما يعكس ثقة في الموقف وعدم حاجة إلى مجاراة سياسية. هذا الصمت المدروس رسالة في حد ذاته: الجزائر لم تتلقَّ الزيارة كطلب ودّ أو مبادرة تحتاج إلى مقابل، بل تعاملت معها كفرصة لتثبيت خطوطها الحمراء وإعادة عرض شروطها بهدوء. وبهذا، تحوّلت الزيارة من محاولة تهدئة فرنسية محدودة، إلى منصة جزائرية لإعادة ترتيب قواعد العلاقة، دون تنازل أو استعجال.
ما الرسائل التي أرادت الجزائر تمريرها من خلال هذه الزيارة؟
أرادت الجزائر من خلال هذه الزيارة أن تُعيد ترتيب سلّم الأولويات في العلاقة مع باريس، عبر تثبيت مضمون الرسائل بدل الانشغال بشكل المبادرة. في مقدمة هذه الرسائل يأتي مبدأ السيادة، ليس كشعار دبلوماسي، بل كقاعدة حاكمة لأي تواصل مستقبلي. السماح بطرح هذا المبدأ علنا، ومن داخل الجزائر، يؤكد أن زمن إدارة الخلافات في الكواليس قد انتهى، وأن أي مسار جديد يجب أن ينطلق من اعتراف صريح باستقلال القرار الجزائري ورفض أي مقاربة فوقية أو وصاية سياسية أو رمزية. الرسالة الثانية تمسّ ملف الذاكرة بكل ثقله التاريخي والإنساني، حيث بدا واضحا أن الجزائر لم تعد تقبل بتجزئة هذا الملف أو تأجيله أو التعامل معه بانتقائية. الحديث عن الأرشيف، والممتلكات الثقافية، ورفات الشهداء، والتجارب النووية في الصحراء، لم يُطرح كعناوين تفاوضية قابلة للأخذ والرد، بل كحقوق ثابتة مؤجلة التنفيذ. الإشارة إلى هذه الملفات في خطاب علني، ومن دون ردّ جزائري توضيحي أو تفسيري، يعكس قناعة بأن النقاش لم يعد حول “هل”، بل حول “متى وكيف”، ضمن مسار اعتراف وتصحيح لا مساومة فيه. أما الرسالة الأعمق، فتتعلق برفض ما يمكن تسميته بـ“العلاقات الرمادية”، أي تلك التي تقوم على التعايش مع التوتر، أو إدارة الخلاف دون حله، أو تبادل الإشارات دون قرارات. الجزائر أوضحت، دون أن تقول ذلك مباشرة، أن المرحلة المقبلة لا تحتمل الغموض ولا الخطابات المزدوجة. فإما علاقة واضحة المعالم، بشروط متفق عليها ومعلنة، أو استمرار القطيعة السياسية الباردة. وبهذا المعنى، لم تكن الرسائل المطروحة جديدة في مضمونها، لكنها بدت هذه المرة نهائية في صياغتها، موجّهة ليس فقط لباريس اليوم، بل لأي قيادة فرنسية تفكّر في إعادة بناء العلاقة غدًا.
لمن وُجّهت هذه الرسائل فعليًا؟ ماكرون أم من بعده؟
وتتجاوز الرسائل التي مرّرتها الجزائر عبر هذه الزيارة حدود مخاطبة الرئيس الفرنسي الحالي، لتتجه بوضوح نحو أفق أوسع يرتبط بما بعد ماكرون. فمع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2027، يدخل المشهد السياسي في فرنسا مرحلة إعادة تشكّل، تتراجع فيها ثوابت قديمة، وتبرز شخصيات وخطابات جديدة تبحث عن تموضع داخلي وخارجي مختلف. وفي هذا السياق، تبدو الجزائر واعية بأن الرهان الحقيقي لا يقتصر على إدارة العلاقة مع قاطن الإليزيه اليوم، بل على التأثير في الإطار المرجعي الذي سيحكم تفكير من سيصل إليه غدًا. هذا الوعي الاستشرافي يفسر طريقة التعامل الهادئة والمتزنة مع زيارة سيغولان روايال، حيث لم تُقرأ الزيارة كردّ فعل آني على توتر ظرفي، بل كفرصة لإعادة ترسيم قواعد اللعبة السياسية مع فرنسا كدولة، لا مع رئيس بعينه. الرسائل التي سُمح بمرورها، والمتعلقة بالسيادة والذاكرة والملفات العالقة، وُضعت في سياق طويل المدى، وكأن الجزائر تقول إن أي مشروع سياسي فرنسي مقبل، مهما كان لونه أو مرجعيته، سيجد أمامه هذه الشروط كأرضية ثابتة لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها. وبهذا المعنى، فإن المخاطَب الحقيقي بهذه الرسائل هو المستقبل السياسي الفرنسي برمّته. الجزائر لا تفاوض مرحلة، بل تؤسس لمسار، ولا تراهن على تغيير نبرة خطاب، بل على تغيير منطق العلاقة نفسه. هي مقاربة تعكس دولة تفكر بثقة في موقعها الإقليمي والدولي، وتتعامل مع التحولات السياسية في الجوار الأوروبي بعقل بارد وحسابات دقيقة، واضعة نصب عينيها أن ما بعد ماكرون يجب أن يُبنى على وضوح كامل، لا على ترميم مؤقت لعلاقة مأزومة. في ضوء كل ما سبق، تبدو زيارة سيغولان روايال محطة دلالية أكثر منها حدثا دبلوماسيا تقليديا، إذ كشفت عن لحظة تقاطع بين رغبة فرنسية في خفض منسوب التوتر، وإرادة جزائرية في إعادة ضبط بوصلة العلاقة على أسس واضحة. فالجزائر، وهي تستقبل الزيارة دون اندفاع أو تصعيد، اختارت إدارة المشهد بهدوء محسوب، مستثمرة الظرف السياسي دون الوقوع في فخ ردود الفعل الآنية أو الحسابات الظرفية الضيقة. هذا التعاطي يعكس انتقال الجزائر من منطق تسيير الأزمات إلى منطق ترسيم الشروط، حيث لم تعد العلاقة مع باريس تُدار بمنطق المجاملات أو المساحات الرمادية، بل ضمن إطار سياسي صريح يحدد ما هو مقبول وما لم يعد كذلك. الرسائل التي مرّت عبر هذه الزيارة لم تُطرح كملفات تفاوضية مفتوحة، بل كمعطيات ثابتة تشكل أرضية أي علاقة مستقبلية، بما يجعل من احترام السيادة، ومعالجة الذاكرة، وحسم الملفات العالقة عناصر غير قابلة للتأجيل أو التمييع. وعليه، فإن أهمية هذه الزيارة لا تكمن في ما حققته آنيا، بل في ما أسست له استراتيجيا، إذ وجّهت الجزائر خطابًا هادئًا لكنه حازم إلى باريس الحالية والمقبلة مفاده أن زمن إدارة العلاقات بالحد الأدنى قد انتهى. هي رسالة تُثبت أن الجزائر، وهي تنظر إلى ما بعد ماكرون، تضع نفسها كشريك يُحترم بشروطه، لا كطرف يُستدعى عند الأزمات، وهو ما قد يرسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، إذا ما أحسن الطرف الآخر قراءة هذه الإشارات.